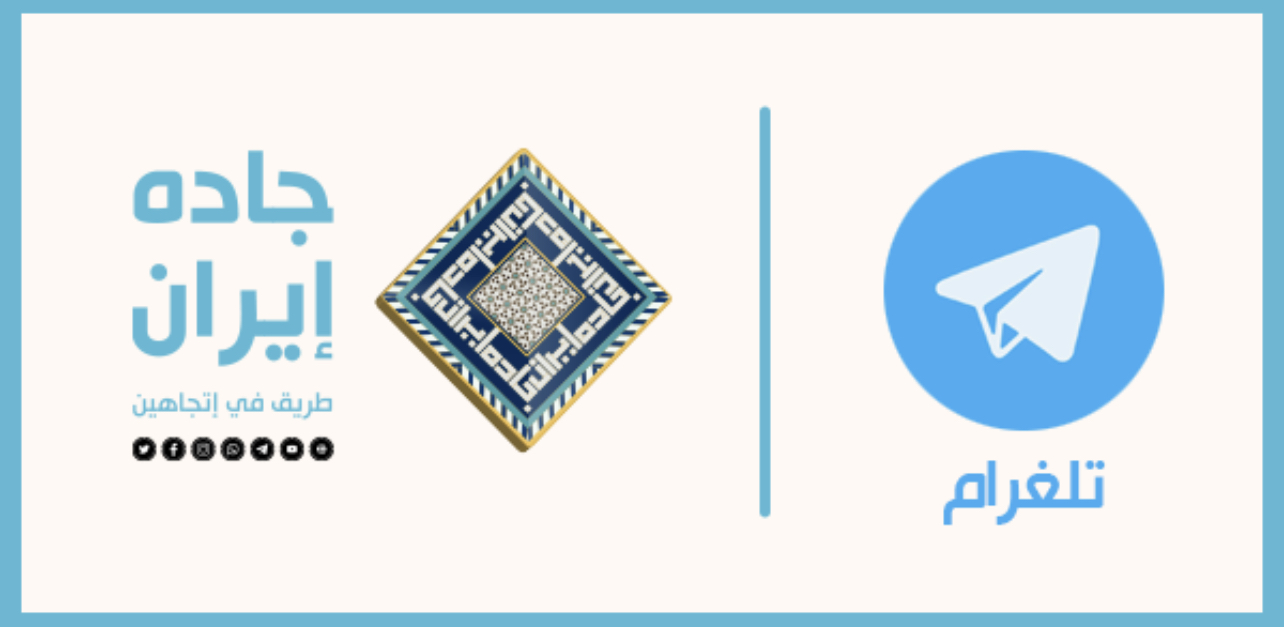استلهمت القصة الإيرانية القصيرة مواضيعها من البيئة المحيطة بها، فكان لمشاكل الأطفال والناشئة نصيب منها، وتناول عدد من الكتّاب في منتصف القرن الماضي، قضية عمالة الأطفال وزواج القاصرات. اخترنا منها اليوم قصة “الوردة الحمراء” للأديب الإيراني المعاصر محمود كيانوش (مواليد 1934م) الذي قدم للقراء أعمالاً شعرية ونثرية ونقدية مميزة خصّ الأطفال منها بآثار عديدة.
“الوردة الحمراء”
كنا نقف قرب الحديقة نشاهد شجيرة ورد الجوري الوحيدة في مدرستنا، وقد تفتحت بعض براعمها. كنا معزولين عن الأطفال الذين يلعبون في الطرف الآخر من الساحة ويتشابكون بالأيادي، وأشعة الشمس تضيء على كل الضجة الخارجية والهمسات الداخلية، وعيوني مأخوذة باللون الأحمر الساطع الذي يشع من الورود المغطّاة بالندى، فيحجب نفسي عن نفسي.
“استاذ استاذ”
عدت إلى نفسي “نعم؟”
“لقد وجدنا هذه.”
كانت قصّاصة أظافر معلقة بسلسلة معدنية.
نظر أحمد إلى الفتاة ثم عاد ليحدق في عينيّ. كنت سارحاً في رقّة الزهور ودفء الشمس، وبروعتها وجاذبيتها. كنت أنظر إلى وجه الفتاة. انحنى وجهها من الخجل وأخذت تركض كأرنب هارب من نظراتنا الجریئة الساخنة، وأخفت نفسها بين الشجيرات وعبث الأطفال.
قال أحمد: “لديها وجه مميز ولا سيما لون عينيها”
قلت له: “لون عينيها مزيج من براءة الطفولة وسحر الأنثى ولطفها”
قال أحمد: “تبدو أكبر من عمرها”
قلت: “نعم في عينيها حياء وخجل وحذر فتاة في الثامنة عشر من عمرها”
قال أحمد: “للأسف لا تعلم مقدار الجمال المزروع فيها”
قلت: “دائماً ما يذهب هذا الجمال والتميز ضحية الفقر والتعاسة. العيون هنا لا تعرف العدالة لا في وجوه الناس ولا اسمائهم ولا ممتلكاتهم، حتى أنا وأنت، اذا دققت في القضية فنحن أيضاً هكذا”
“لا أعرف ربما أنا لست هكذا”.
كان عمرها إحدى عشرة سنة، في الصف الرابع الابتدائي، ذكية، لكنها مشاغبة، تقطع مشياً مع أخيها وثلاثة تلاميذ آخرين ساعة كاملة من قريتهم ليصلوا إلى المدرسة. كانت يتيمة الأم، وعمر والدها سبعة أو ثمانية وأربعين سنة انهكته الحياة. كان يعمل في كل شيء . يحمل محصول البصل والبطاطا إلى المدينة، يسمد الحقول، يسقي الأرض، ومشاغل أخرى. عيونها كانت ملونة بين العسلي والأصفر، تحترق فيهما شعلتين من الذهب، شعلة بلون دخان الحشيش وطعم الخلسة، لوجهها نضارة ولون وجمال بعض دمى الألعاب، تخفي وراء حمرة خجلها أسراراً، لو أني لا أشيح بنظري عنها فأنظر في الأرض أو مكان آخر لكانت عيناي المسحورة كشفتني.
تفتحت آخر وردة جورية في حديقة المدرسة وسقطت أوراقها أيضاً، كانت شجرة المشمش القصيرة تبدو من نافذة الصف متعبة الأغصان تتمايل مع نسمات الخريف، مكان الفتاة في المقعد الثاني كان فارغاً، نظرت إلى التلميذ الذي كان يأتي معها من القرية. تحرك الصبيّ قليلاً وانشغل بدفتره ثم فتح كتابه، واختلس نظرة إلى مكان الفتاة.
قلت له: “أين تلك السحلية؟”
ضحك التلاميذ وقال الصبيّ: “تخجل من المجيء”
قلت له: “ممّ تخجل؟”
ضحك بعضهم بصوت عالٍ مرة ثانية، وقال صبيّ آخر: “استاذ نحن نعلم أنها تخجل، جاءت معنا حتى نصف الطريق”.
قالت فتاة في آخر الصف: “لقد استهزأ بها الأطفال، وقالوا لها كلامًا سيئًا، هذا قاسم”.
ضج الصف، لم أفهم شيئًا حتى تلك اللحظة. شعرت أنّ عليّ أن أقلق كمعلم وأكبح جماح فضول الرجل داخلي، فلا أشوه بيني وبين نفسي وجهي المسؤول.
صرخت بهم بغضب: “اخرسوا! افتحوا كتبكم، عباس تعال إلى السبورة!”
حلّ الهدوء على الصف من جديد، تركت فضولي وأسئلتي جانباً إلى وقت الاستراحة، رن جرس الصف أخرجت الجميع من الصف وأبقيت قاسم، وقلت له إنني احتاجه، أغلقت باب الصف وبصوت جاف وعصبي بدأت:
“قل لأفهم”
“أستاذ، نحن لم نزعجها”
“لماذا رجعت إذاً؟
“تخجل منك، هي قالت ذلك، لقد هنّأها الجميع هي وكريم جعفر آبادي”
“كريم جعفر آبادي؟”
“نعم، يبيع أغطية نايلون في المدينة، ومرايل مطبخ وأشياء للأطفال”
“يعني خطبها؟”
“نعم، أم والد كريم جارتنا، وأبوه يعمل لدى البيك”
“ولماذا هزئتم بها؟”
“نحن لم نستهزئ بها، بل رضا بادي هو من أزعجها، كان يرميها بالكلام، والله نحن لم نفعل ذلك”
فتحت باب الصف وقلت له: “اذهب لا تزعجها ثانيةً، كل الفتيات سيتزوجن”.
لم تأتِ بعدها إلى المدرسة، أعطينا أوراقها لأخيها، كان على ورقة تسجيلها في الصف الرابع صورة، وثلث علاماتها كانت متوسطة، أمعنت النظر في صورتها، عادت لها نضارتها فتحركت عيناه ولمعتا. قامتها طويلة، نحيلة، مع انحناءات جسد امرأة جاءت من خلف الشاشات، مفعمة بالحيوية في لباسها البنفسجي المحاك من الحرير المضيء، وكأنه نسيم وعليه ندى.
بقي مقعد زهرا فارغاً كما كان وبدأ البرد يهبط قليلاً قليلاً، لكن أوراق شجرة المشمش لم تسقط بالكامل، كنت انظر من النافذة إليها كأنها يد ترفع بأصابعها نحو السماء وتدعو كل الأدعية، أعدت رأسي نحو الصف. الكل كان نائمًا، قلت:
“ضعوا الوظائف أمامكم على المقعد”.
حفيف أوراق الدفاتر ملأ الصف، لم أصل بعد في تصليح الوظائف إلى المقعد الثاني، حتى جاء صوت من الخلف: “استاذ، هل تسمح لي؟ قاسم خرج من الطريق وهو الآن غائب”.
لم أرفع رأسي، ولم أجب، عاد الصوت ثانية: “لقد هرب من خوفه لأنه لم يكتب الوظيفة”
قال تلميذ آخر: “لقد كان أمس في العرس”.
رفعت رأسي كمعلم وصرخت: “اخرسوا! لا دخل لكم بهذا الأمر. يكفيكم ثرثرة عندما أسألكم أجيبوا”.
وقت جرس الاستراحة، عند حديقة الباحة، قرب شجيرة وردة الجوري العارية، وقفت، وفسحت المجال للتلاميذ أن يتجاوزوا حدودهم ويقولوا ما يدور في خاطرهم. كنت أنظر إليهم وكأني لا أرغب في سماع ما يقولون أبداً.
“مضى أسبوع ولم يأت كريم جعفر آبادي من المدينة، أمّه تبكي وتدمع وتلعن”.
“والد زهرا تراجع عن كلمته، وأعاد لهم خاتم وفستان كريم”.
“حبيب نجار رأى كريم في المدينة، يقول كأن كريم قد أصابه جنون”.
“کان يرغب بزهرا كثيراً”
“زهرا أصبحت زوجة سيد ولي صاحب البقر، أبوها أعطاها له وأخذ عوضاً عنها بغل، ومنذ أيام نفق البغل”.
قال عباس أكبر الجميع “سيد ولي من عمر أبي زهرا ولديه امرأة وثلاثة أطفال”.
رفعت يدي عالياً وأشرت إلى الطرف الآخر من ساحة المدرسة وقلت بصرامة: “يالله! توقفوا عن الكلام الفارغ! اذهبوا”.
عدت إلى وحدتي وقفت إلى جانب الحديقة. كنت أتأمل الأغصان الخالية من الورود الحمراء، حاولت أن اتذكر وجه الفتاة، لقد هرب خيالها معها. في لحظة تخيل لي بريق عينيها وكأن شجيرة الورد الجوري قد اشتعلت.
الجادّة: طريقٌ في اتجاهين